
الملَّخص
تناول الكاتبُ في مقالتِه حولَ سورةِ التَّوحيد إلى دراستها وتحليل مضامينها، ففي الفصل الأوَّل تعرَّض إلى فضلها، وخصائصها، وسبب نزولها، وأسمائها ودلالاتها، وفي الفصل الثاني تعرض إلى تفسير آياتها ومعانيها، وتوسَّع في الفصل الثالث في موضوعات مرتبطة بالسورة، وقد شملتْ: شرافة علم التَّوحيد، وبعض أحكام قراءة سورة التَّوحيد، وأقسام التَّوحيد، وأدلَّة التَّوحيد الواحديِّ والأحديِّ، بطريق العقل والنَّقل، وبيان نظريَّة التَّثليث ونقدها، وعرض شبهتين على التَّوحيد وردِّهما، وهما: أطروحة الثَّنوية، وتنافي السُّجود لآدمg مع التَّوحيد في العبادة.
المقدِّمة
{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ هو الله أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمد * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ} (الإخلاص:1-4)
بِسم الله والحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل بيته الطَّيِّبين الطّاهرين، واللَّعن الدّائم المؤبَّد على أعدائهم إلى قيام يوم الدّين وبعد..
إنَّ تفسير القرآن الكريم من أكثر العلوم الإسلامية دراسة، حيث صُرفت جلُّ جهود العلماء والفقهاء في تفسير معاني ومفاهيم القرآن الكريم، فالقرآن الكريم هو بحر واسع وعميق، ومن تعمَّق في فهم معانيه وآياته لاقى الجواهر فينعم بها في دنياه ويفوز بفضلها في آخرته، فهو المعجزة الخالدة الَّتي أيَّد الله تبارك وتعالى بها نبيَّه الكريمe، وحريٌّ بنا أن نعمل على فهم كلمات هذا الكتاب المقدَّس، ومن الواضح أنَّ فهم معانيه والتّعمُّق فيها يزيد الإنسان تعلُّقاً به، ومن هنا أحببت أن أكتب في هذا الجانب وبالخصوص في سورة التَّوحيد لكون هذه السّورة المباركة ممّا يكثر قراءتها بشكلٍ يوميٍّ في الصَّلوات اليوميَّة.
وفي البحث عن هذه السّورة المباركة فوائدُ عديدة، ولكنْ سأقتصر على ذكر الفائدة الأهمِّ وهي تقوية عقيدة الإنسان بهذا الأصل المهمِّ من أصول الدّين ألا وهو التَّوحيد؛ إذ إنَّ هذه السّورة المباركة تهدف إلى ترسيخ هذا الأصل المهمِّ، فمن خلال معرفة معاني هذه السّورة المباركة يتعرَّف الإنسان إلى هذا الأصل ويقوّي عقيدته به، خصوصاً حين النَّظر إلى الأدلَّة عليه كما سيوافيك ذلك في الفصل الثّالث إن شاء الله تعالى، والله ولي التّوفيق.
الفصل الأول: مباحثُ تمهيديَّةٌ
المبحث الأول: فضل سورة التَّوحيد
على الرّغم من صِغَر وقلَّة عدد آيات هذه السّورة المباركة إلا أنَّ لها العديد من الفضائل، فقد وردت في فضيلة هذه السّورة المباركة نصوص كثيرة تدلُّ على مكانة هذه السّورة بين سُور القرآن، والمراد من فضلها هو البركات التي يتحصَّل عليها الإنسان من خلال قراءته لهذه السّورة، وهذه البركات كثيرة جداً تتعلَّق بحياة البشر سواء على مستوى الحياة المادية أو الحياة المعنوية وإليك بعضها:
1. قراءة هذه السّورة المباركة تجلب حبَّ الله:
ففي الرِّواية عن النَّبي الأكرمe أنَّه قال: >مَنْ قَرَأَ هَذِهِ اَلسُّورَةِ وأَصْغَى لَهَا أَحَبَّهُ اَللَّهُ، ومَنْ أَحَبَّهُ اَللَّهُ نَجَا<([1]).
2. من قرأ هذه السّورة المباركة كان كمن قرأ ثلث القرآن:
فقد ورد عن رسول اللهe أنَّه قال: >أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ كُلَّ لَيْلَةٍ ثُلُثاً مِنَ اَلْقُرْآنِ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اَللَّهِ، مَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: >يَقْرَأُ مَرَّةً قُلْ هُوَ اَللَّهُ أَحَدٌ فَكَأَنَّمَا قَرَأَ ثُلُثَ اَلْقُرْآنِ<([2]).
وهنا يمكن الإشارة إلى لفتة لطيفة وهي أنَّ النَّبيe قد أثار هذه المسألة بصيغة السُّؤال حتّى يثيرهم ثمَّ يعطيهم الجواب، وذلك من أجل أن يترسَّخ الجواب في الذّهن ويتشجَّع الآخرون على فعلها.
ومن خلال الرِّواية نفهم أنَّه مَن قرأ هذه السّورة ثلاث مرات كان كمن ختم القرآن كلَّه، وبهذا المضمون رواية أيضاً، فقد رُوي عن رسول اللهe أنَّه قال:>مَنْ قَرَأَ {قُلْ هُوَ اَللَّهُ أَحَدٌ} مَرَّةً فَكَأَنَّمَا قَرَأَ ثُلُثَ اَلْقُرْآنِ، وَمَنْ قَرَأَهَا مَرَّتَيْنِ فَكَأَنَّمَا قَرَأَ ثُلُثَيِ اَلْقُرْآنِ، وَمَنْ قَرَأَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَكَأَنَّمَا قَرَأَ اَلْقُرْآنَ كُلَّهُ<([3])، وقد وجَّه البعضُ معنى أنَّ السّورة تعدل ثلث القرآن بأنْ قالوا: إنَّ ما في القرآن من المعارف تنحلُّ إلى الأصول الثَّلاثة: التَّوحيد والنّبوة والمعاد، والسّورة تتضمَّن واحداً من الثّلاثة ألا وهو التّوحيد، وقال البعضُ الآخر بأنَّ ذلك -أي كون السّورة المباركة تعدل ثلث القرآن- لأنَّ ثلث موضوعات القرآن تقريباً تدور حول التَّوحيد وجاءت عصارتها في هذه السّورة المباركة، وقال بعضٌ: سبب ذلك أنَّ القرآن على ثلاثة أقسام: المبدأ والمعاد وما بينهما وهذه السّورة تشرح القسم الأوَّل([4]).
3. قارِئها يجمع خير الدّنيا والآخرة:
ففي الرِّواية عن رسول اللهe أنَّه قال: >مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ واَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ فَلاَ يَدَعْ أَنْ يَقْرَأَ فِي دُبُرِ اَلْفَرِيضَةِ بِ {قُلْ هُوَ اَللَّهُ أَحَدٌ}؛ فَإِنَّهُ مَنْ قَرَأَهَا جُمِعَ لَهُ خَيْرُ اَلدُّنْيَا واَلْآخِرَةِ، وغُفِرَ لَهُ ولِوَالِدَيْهِ ومَا وَلَدَ<([5]).
4. يبعث الله لقارئها سبعين ألف ملَكاً وفيهم جبرئيلg يصلّون عليه:
ففي الرِّواية عن الإمام الصّادقg أنَّه قال: >أَنَّ اَلنَّبِيَّ e صَلَّى عَلَى سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَقَالَ: لَقَدْ وَافَى مِنَ اَلْمَلاَئِكَةِ سَبْعُونَ أَلْفاً وفِيهِمْ جَبْرَئِيلُ g يُصَلُّونَ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا جَبْرَئِيلُ، بِمَا يَسْتَحِقُّ صَلاَتَكُمْ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: بِقِرَاءَتِهِ {قُلْ هُوَ اَللَّهُ أَحَدٌ} قَائِماً، وقَاعِداً، ورَاكِباً، ومَاشِياً، وذَاهِباً، وجَائِياً<([6]).
5. قراءة هذه السّورة عند دخول البيت تزيد في الرِّزق وتدفع الفقر:
فقد رُوي عن الامام الصّادقg أنَّه قال: >إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ مَنْزِلَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى أَهْلِهِ يَقُولُ: اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَهْلٌ فَلْيَقُلِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا مِنْ رَبِّنَا، ولْيَقْرَأْ {قُلْ هُوَ اَللَّهُ أَحَدٌ} حِينَ يَدْخُلُ مَنْزِلَهُ فَإِنَّهُ يَنْفِي اَلْفَقْرَ<([7]).
وهناك بركات أخرى وعديدة يحصل عليها قارئ هذه السّورة المباركة، فالرِّوايات في فضيلة هذه السّورة أكثر من أن تستوعبها هذه السُّطور وما نُقل ليس إلا جزءاً يسيراً منها، ولكنَّنا نقتصر على هذا القدر، ولذا -لا أقل- قبل النَّوم من الجيِّد أنْ يواظب الإنسان على قراءة هذه السّورة العظيمة حتى يتحصَّل على البركات الَّتي ينالها قارئها، وفي ختام هذا المبحث من الجيِّد ألا يستكثر الإنسان هذه البركات الَّتي يتحصَّل عليها قارئ هذه السّورة العظيمة؛ إذ إنَّه لو عرض على ميزان العقول لقُبل وذلك لأنَّ الحقائق يقدِّرها مَن يعرفها ويعرف حقيقتها.
المبحث الثّاني: خصائص سورة التَّوحيد
لهذه السّورة المباركة خصائص عدَّة نذكر بعض منها:
الخصيصة الأولى: [وصف جامعٌ للتّوحيد على قصرها]
إنَّ السّورة في أربع آيات قصار تصف التَّوحيد بشكلٍ جامعٍ من دون حاجة إلى أيَّة إضافة، فهذه السُّورة تتناول الذّات الإلهيَّة في أخصِّ خصائصها وأعظم مقوِّماتها وهي توحيده سبحانه في ذاته بحيث لا يشابهه أحد، فهو متفرِّد في تلك الذّات العليَّة، وإليه يرجع الخلق في وجودهم واستمراريَّة ذلك الوجود، فجاءت هذه السّورة المباركة مشتملة على أهمِّ أركان الدّين؛ إذ احتوت الحديث عن التَّوحيد الَّذي هو جوهر الدّين، وهو -أي التَّوحيد- الَّذي بعث الله تعالى الأنبياء جميعاً لدعوة النّاس إليه.
الخصيصة الثّانية: [تواتر أحاديث المعصومينi في بيان أهمّيّتها]
إنَّ الأحاديث الشّريفة قد تواترت عن المعصوم في بيان أهمِّيَّتها ومكانتها العالية في ميزان الإسلام، فمثلاً تواترت الرِّوايات المروية عن المعصوم في مسألة الاستحباب من الإكثار في قراءة سورة الإخلاص وتكرارها ألف مرة في كلِّ يوم وليلة، وكراهة تركها فقد روي عن النّبي الأكرمe أنَّه قال: >من قرأ قل هو الله أحد مائة مرَّة حين يأخذ مضجعه غفر الله له ذنوب خمسين سنة<([8]).
وغيرها من الخصائص المذكورة لهذه السّورة المباركة لكنَّنا نكتفي بهذا المقدار.
المبحث الثّالث: سبب نزول سورة التَّوحيد
اختُلف في كون هذه السّورة المباركة في أنَّها سورة مكيَّة -أي أنَّها نزلت في مكة- أو مدنيَّة -أي نزلت في المدينة-، ولكنَّ الأكثر على أنَّها مكيَّة([9])، وأمّا سبب النّزول فقد رُوي في الكافي عن أبي عبد الله الإمام الصّادقg أنَّه قال: >إنَّ اليهود سألوا رسول اللهe فقالوا: انسب لنا ربَّك -أي صفْ لنا ربَّك- فلبث فيهم ثلاثا لا يجيبهم، ثمَّ نزلت السّورة المباركة (سورة التَّوحيد)<([10]).
المبحث الرّابع: في ذكر بعض التَّسميات لهذه السّورة مع ذكر السَّبب التَّسمية
تُسمَّى هذه السّورة بعدَّة أسماء تصل إلى عشرين اسماً([11])، ومن ضمن هذه التَّسميات:
1. سورة التَّوحيد، وسميت بهذا الاسم؛ لأنَّها تتكلَّم عن هذا الأصل الأوَّل من أصول الدّين وهو التَّوحيد.
2. سورة الإخلاص، وقد تعدَّدت الأقوال في سبب تسميتها بهذا الاسم؛ فقيل: سُمِّيت بهذا الاسم؛ لأنَّها تتضمَّن معنى الإخلاص لله تبارك وتعالى، وقيل: سُمِّيت بهذا الاسم؛ لأنَّ فيها تعليم النّاس إخلاصَ العبادة لله تعالى، أي أنَّ المعتقد بها يسلم من الشّرك مع الله في الألوهية، وقيل: إنَّها سُمِّيت بهذا الاسم، لأنَّ المتمسِّك بها عن يقين واعتقاد تكون سبيلَه إلى النّجاة والخلاص في الآخرة، وغيرها من الأسباب الَّتي ذكرت في وجه تسميتها بهذا الاسم.
3. سورة المقشقشة، فالتّقشيش بمعنى الشّفاء حيث يقال: تقشيش المريض أي شفاؤه، ويرجع السّبب في هذه التّسمية إلى أنَّ السّورة الكريمة سبب للبراءة من الشّرك والنِّفاق.
4. سورة الأساس، وسُمِّيت بهذا الاسم؛ لأنَّها تتكلَّم عن أساس الدّين وقوامه المتمثل بالتَّوحيد.
الفصل الثّاني: تفسير سورة التَّوحيد
بعد أن عرفنا سبب النّزول -من أنَّ اليهود طلبوا من رسول اللهe أنَّ يصف لهم الله تبارك وتعالى، جاء الخطابُ مِن الله تبارك وتعالى للنَّبيِّe بقوله تعالى {قل}، فالله تبارك وتعالى يأمر النَّبيِّ eبالقول والتّكلم وإظهار هذه الحقيقة الغامضة بما ذكر في السّورة من آيات، ولْنقف مع كلِّ آية من آيات هذه السّورة المباركة:
أولاً: في قوله تعالى {قُلْ هو الله أَحَدٌ}:
وفي هذه الآية نقف مع ذكر أمور:
الأمر الأوَّل: [الضّمير {هو}]
نقف مع الضّمير {هو} المذكور في الآية، ونشير لبعض الإشارات:
الإشارة الأولى: من الواضح أنَّ هذا الضَّمير يُستعمل ويشار به للمفرد الغائب، واستعمل الله تبارك وتعالى هذا الضَّمير ليبيِّن أمراً مهمّا، فالله تبارك وتعالى يريد أنْ يشير إلى أنَّ الذّات المقدَّسة هي في نهاية الخفاء، لا تدركها الأبصار ولا تنالها أفكار الإنسان، ولذا ورد عن الإمام محمَّد بن عليّ الباقرg أنَّه قال: في هذه الآية - آية {قل هو الله أحد}-: >أنَّ الكفار نبهوا عن آلهتهم بحرف إشارة الشّاهد المدرك، فقالوا: هذه آلهتنا المحسوسة المدركة بالأبصار، فأشر أنتَ يا محمَّد إلى إلهك الَّذي تدعو إليه حتّى نراه وندركه ولا نأله فيه، فأنزل الله تبارك وتعالى {قل هو الله أحد} فالهاء تثبيت للثابت، والواو إشارة إلى الغائب عن درك الابصار ولمس الحواس<([12])، فمِن خلال الإتيان بالضَّمير -هو- نفهم أنَّ الله أراد أنْ يشير بأنَّ ذاته المقدَّسة في نهاية الخفاء.
الإشارة الثّانية: الضَّمير (هو) هو ضمير الشّأن، وهو يفيد الاهتمام بمضمون الجملة التّالية فجيء به؛ من أجل الإشارة إلى أهمِّيَّة مضمون الجملة التّالية له([13]).
الأمر الثّاني: نقف مع المعنى المراد من لفظ الجلالة {الله}:
ينقسم اللَّفظ باعتبار المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه إلى عدَّة أقسام، منها: اللَّفظ المختصُّ، وهو اللَّفظ الَّذي ليس له إلا معنىً واحد فاختُصَّ به، ولفظ الجلالة -الله- لفظ مختصٌّ بالذّات الإلهيَّة ولا يطلق على غيرها، وهذا اللَّفظ مشتقٌّ مِن معنى وصفي (وله) أي تحيَّر، فمشتقٌّ من المصدر (التَّحيُّر) وذلك؛ لأنَّ العقول تتحيَّر في ذاته المقدَّسة، ولذا قال أميرُ المؤمنينg في معناه -أي في معنى لفظ الجلالة- أنَّه: >المعبود الَّذي يأله فيه الخلق ويُؤله إليه، والله هو المستور عن درك الأبصار، المحجوب عن الأوهام والخطرات<([14])، وقال الإمام الباقرg: >الله معناه: المعبود الَّذي أله الخلق عن درك ماهيته والإحاطة بكيفيته<([15]).
الأمر الثّالث: نقف مع المعنى المراد من قوله تعالى {أحد}:
لفظة (أحد) وصف مأخوذ من الوحدة، وفي أقوال العلماء يفرِّقون بين لفظة أحد وبين لفظة واحد، فقالوا لفظة أحد تُطلق على الذّات الَّتي لا تقبل الكثرة لا في الخارج ولا في الذِّهن -أي أنَّ هذه الذّات بسيطة غير مركبة-، بينما لفظة الواحد فهي في قبال أنواع الكثرة الخارجية([16])، فعندما قال تعالى {قُلْ هو الله أَحَدٌ} أراد أنْ يشير إلى أنَّ ذاته بسيطة غير مركَّبة، وفي قوله إشارة إلى أنَّ ذاته تعالى في قبال الأجزاء التَّركيبيَّة سواء الخارجيَّة أو العقليَّة، وسيوافيك في الفصل الثّالث الأدلَّة العقليَّة والنَّقليَّة على بساطة ذاته تعالى فترقَّبْ.
فالحاصل من هذه الآية المباركة {قل هو الله أحد} أنَّ الله تبارك وتعالى أمر النَّبيَّe بأنْ يُخبر بأنَّ ذات الله تبارك وتعالى بسيطة غير مركبة، لا تدركها الأبصار ولا تنالها أفكار الإنسان، ويُطلق على هذا المعنى بالتَّوحيد الأحديِّ.
ثانياً: في قوله تعالى {اللَّهُ الصَّمد}:
وفي هذه الآية نقف مع ذكر أمرين:
الأمر الأوَّل: في سبب تكرار لفظ الجلالة مرَّة أخرى في الآية الثّانية
فإنَّه قد يقول قائل: بما أنَّه قد ذكر لفظ الجلالة -الله- في الآية الأولى فما الدّاعي لتكراره مرَّة أخرى في الآية الثّانية حيث قيل {الله الصَّمد} ولم يقل هو الصَّمد؟
فيذكر العلماء بأنَّ إظهار لفظ الجلالة مرة أخرى لسبب، وهو من أجل الإشارة إلى كون كلٍّ من الجملتين -الآية الأولى والآية الثّانية- لوحدها كافية في التَّعريف بالذّات المقدَّسة؛ إذ إنَّ المقام هو تعريف الذّات الإلهيَّة بصفة تختصُّ بها، فلمّا قيل {الله الصَّمد} ففيه إشارة إلى أنَّ تعريف الذّات يصحُّ بما ذكر في الآية الأولى، وهو قوله تعالى {قل هو الله أحد}، ويصحُّ بما ذكر في الآية الثّانية وهو قوله تعالى {الله الصَّمد}([17]).
الأمر الثّاني: في بيان المراد من قوله تعالى {الصَّمد}:
لفظة الصَّمد هي وصف لذات الله تبارك وتعالى -كما تقدَّم بيان ذلك في الأمر الأوّل-، وقد ذُكرت لمفردة الصَّمد معانٍ كثيرة، ولكن يقول العلماء بأنَّ كلَّ ما ذكر من معاني لهذه المفردة لها أصلان لغويان وهما:
أ.القصد. ب. الصّلابة في الشَّيء.
ومن ضمن المعاني الَّتي ذكرت لمفردة الصَّمد أنَّها بمعنى السَّيد المقصود إليه في الحوائج، ومنها أنَّها بمعنى الشّخص الَّذي لا ينام، ومنها أنَّها بمعنى الشّخص الَّذي لا يأكل ولا يشرب([18])، وغيرها من المعاني، ولكنَّ المعنى الَّذي ذكره أغلب المفسِّرين هو أنَّ الصَّمد بمعنى القصد مع الاعتماد، فالصَّمد بمعنى السّيد المقصود إليه في الحوائج فقد ذكر هذا المعنى جملةٌ من الأعلام كصاحب تفسير الأمثل وصاحب تفسير الميزان وغيرهما من الأعلام.
وهنا في الآية توجد لفتة لطيفة، وهي إطلاق الكلام فقيل {الله الصَّمد} ولم يخصِّص أنَّه صمد في شي معيَّن، وهذا يدلِّل على أنَّ الله تبارك وتعالى هو مقصود إليه في جميع الحوائج على الإطلاق فهو الكامل من كلِّ الجهات([19])، وإلى هذا المعنى أشار تعالى بقوله في موضع آخر {أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ}(الأعراف: 54)، وبقوله تعالى {وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى}(النَّجم: 42)، وغيرها من الآيات والرِّوايات في ذلك.
فالحاصل من هذه الآية {الله الصَّمد}، هوالإشارة إلى أنَّه تعالى هو السّيد الَّذي يقصد إليه في جميع الحوائج على الإطلاق، وإن كانت هناك معانٍ أخرى لمفردة الصَّمد.
ثالثاً: في قوله تعالى {لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ}
هذه الآية ترد على مَن يؤمن بالتَّثليث، وسيوافيك بيان هذه النّظريَّة- نظريَّة التَّثليث - والرّد عليها في الفصل الثّالثّ، وفي هذه الآية نقف مع ذكر أمرين:
الأمر الأوَّل: في قوله تعالى {لم يلد}
أي لم يخرج منه شيء، فالله يريد أنْ يُشير إلى أنَّه لم يتخذ ولداً، وهذا تنزيه لساحته تعالى عمّا ادَّعاه له بعض النّاس، حيث قالت النّصارى: المسيح ابن الله، وحيث قال اليهود : عزير ابن الله، فهنا، الله تبارك وتعالى يريد أن ينفي أن يكون له ولد؛ وذلك لأنَّ التّوالد الطّبيعي يحتاج إلى زوجة والله تبارك وتعالى منزَّه عن أنْ تكون له زوجة وصاحبة، فقد قال تعالى {بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ}(الأنعام: 101)، فلا يمكن أنْ يكون لله تبارك وتعالى ولد؛ لأنَّ القول بذلك يستلزم أنْ يكون له صاحبة متجانسة معه، وهو سبحانه منزَّه عن المجانسة؛ إذ هو واجب الوجود الَّذي ليس له نظير ولا مثيل.
الأمر الثّاني: في قوله تعالى {ولم يولد}
أي أنَّه لم يولد ولم يخرج من شيء وغير مشتقٍّ، إذ إنَّه سبحانه وتعالى قديم، ويقال أيضاً بأنَّ المتولِّد يحتاج إلى والد ووالدة والله غني بالذّات والصِّفات فلا يكون مولوداً.
فالحاصل من هذه الآية {لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ} هو نفي كونه تعالى والد ومولود، فقوله تعالى {لَمْ يَلِدْ } تنفي عنه تعالى أنْ يلد شيئاً، وقوله تعالى {وَلَمْ يُولَدْ} تنفي عنه تعالى أنْ يكون متولداً من شي آخر وأنَّه ليس مشتقاً من أيِّ شي آخر بأيِّ نحوٍ أريد من الاشتقاق، ولذا ورد عن أمير المؤمنينg أنَّه قال: >لَمْ يَلِدْ فَيَكُونَ مَوْلُوداً، ولَمْ يُولَدْ فَيَصِيرَ مَحْدُوداً..<([20]).
رابعاً: في قوله تعالى {وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ}
ونقف في هذه الآية مع ذكر أمرين:
الأمر الأوَّل: في المراد من مفردة الكفء:
يذكر في اللغة بأنَّ الكفء لها عدَّة معاني، وأشهرها أنَّه بمعنى الشّبيه والمثيل والشّريك.
الأمر الثّاني: لا نظير له تعالى ولا شبيه
يشير تبارك وتعالى في الآية إلى أنَّه لا نظير ولا شبيه له لا في ذاته ولا في صفاته، فالله منزَّه عن عوارض المخلوقين وصفات الموجودات، وقد رُوي عن النّبي الأكرمe أنَّه قال في هذه الآية: >لَيْسَ لَهُ شَبِيهٌ ولاَ مِثْلٌ ولاَ عَدْلٌ ولاَ يُكَافِيهِ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِهِ بِمَا أَنْعَمَ عَلَيْهِ مِنْ فَضْلِهِ<([21])، ويطلق على هذا المعنى بالتَّوحيد الواحديِّ.
فالحاصلُ من هذه الآية أنَّها تشير إلى عدمِ وجودُ كفء -مثيل ونظير وشريك- لله تبارك وتعالى، فالله نفى أنْ يكون له شريك مثيل.
الفصل الثّالث: في ذكر بعض الوقفات المهمَّة
الوقفة الأولى: حول شرافة علم التَّوحيد
يحتل التَّوحيد المكانة العليا في الشّرائع السَّماوية، وعلم التَّوحيد هو أشرف العلوم على الإطلاق، وله مكانة سامية؛ وذلك لأنَّ الغاية من هذا العلم هي معرفة وجود الخالق تعالى وصفاته المتَّصف بها والمنزَّه عنها، ولهذا العلم أثر في استقامة الفرد وصلاح المجتمع الإنساني؛ لأنَّ صلاح الأعمال رهين بحسن الاعتقاد، ولأنَّ العقيدة هي الرُّكن الرَّكين والأساس المتين الَّذي يقوم عليه الإسلام، وبدونها لا تقام أركانه ولا يستوي نظامه، ولذلك تجد القرآن اهتمَّ اهتماماً بالغاً بإصلاح العقيدة، وترسيخ جذورها، وتطهيرها من الأوهام والشّبهات.
الوقفة الثّانية: وقفة فقهيَّة مع بعض أحكام سورة التَّوحيد
الحكم الأوَّل: يتكلَّم عن طرق قراءة كلمة {كُفُوًا}
وهي الموجودة في الآية الأخيرة من هذه السّورة المباركة، وهي {ولم يكن له كفوا أحد}، فذُكرت لها أربع طرق في قراءتها وهي:
الطّريقة الأولى: بضمِّ الفاء مع الهمزة {كُفُؤاً}.
الطّريقة الثّانية: بضمِّ الفاء مع الواو {كُفُواً}.
الطّريقة الثّالثة: بسكون الفاء مع الهمزة {كُفْؤاً}.
الطّريقة الرّابعة: بسكون الفاء مع الواو {كُفْواً}.
وقد اختلف الفقهاء في جواز جميع الصّور من عدم جوازها، فالسَّيد السّيستاني F، والسّيد الخوئي S، يقولان بجواز وصحَّة جميع الصّور الأربع([22]).
الحكم الثّاني: حكم فقهيٌّ تشترك سورة التَّوحيد مع سورة الكافرون فيه:
يقول الفقهاء أنَّه يجوز العدول اختياراً من سورة لسورة أخرى ما لم يبلغ نصف السّورة الأولى، وإلا لو تجاوز المصلي نصف السّورة الأولى لم يجُز العدول إلى سورة أخرى، ثمَّ يقولون بأنَّ هناك استثناء وهو في خصوص سورتي التَّوحيد والكافرون، فإنَّه لا يجوز العدول عنهما إلى سورة أخرى وإن لم يبلغ نصفهما، فالحاصل أنَّه بمجرد الشُّروع في سورتي التَّوحيد والكافرون لم يجُز العدول منهما لسورة أخرى.
نعم، يوجد مورد واحد يجوز العدول عنهما -عن سورتي التَّوحيد والكافرون- وهو فيما لو قصد المصلي في يوم الجمعة قراءة سورة الجمعة في الرَّكعة الأولى أو سورة المنافقون في الرَّكعة الثّانية لكنَّه ذهل عمّا نواه وقرأ سورة التَّوحيد أو سورة الكافرون، فهنا يجوز له العدول إلى ما نواه -أي إلى سورة الجمعة أو سورة المنافقون- ففي هذا المورد يجوز العدول عن هاتين السّورتين([23]).
الحكم الثالث: [كراهة تركها في مجموع الفرائض اليوميّة]
يذكر الفقهاء أنَّه يُكره عدم قراءة سورة التَّوحيد في إحدى الصَّلوات اليومية الخمس في اليوم كامل.
الوقفة الثّالثة: في ذكر أقسام التَّوحيد
للتَّوْحيد أقسام عدَّة فمنها:
1. التَّوحيد في الذّات:
وهو على نوعين:
النّوع الأول: التَّوحيد الواحديُّ
وهو بمعنى أنَّ الله تعالى واحد في ذاته فلا نظير له ولا شبيه، فلا يوجد أيّ شبيه ونظير وشريك لله تبارك وتعالى.
النّوع الثّاني: التَّوحيد الأحديُّ
بمعنى أنَّ ذاته تعالى ذات بسيطة غير مركَّبة فهو غير مركَّب من أجزاء لا داخلية ولا خارجية، فهو ليس كالإنسان المركب من يد ورجل وغيرها بل هو تبارك وتعالى بسيط غير مركب.
ويتفرَّع على هذا أنَّه ليس بمقدور الإنسان أنْ يتصوَّر الذّات الإلهيَّة؛ وذلك لأنَّ الإنسان بإمكانه أنْ يتصوَّر الأشياء الَّتي لاحظ أمثالها أو الأمور الَّتي تحصَّلت بعد التَّركب، وأمّا الشَّيء الَّذي ليس له أيُّ مثيل والبسيط غير المركب فإنَّه لا يمكن للإنسان أنْ يتصوَّره.
2. التَّوحيد في الصّفات:
وهو بمعنى أنَّ الصِّفات -صفاته تعالى- هي عين الذّات الإلهيَّة، وبعبارة أخرى أنَّه ليس لهذه الصِّفات وجود إلا وجود الذّات، وبعبارة ثالثة أنَّ الصِّفات هي عين الذّات والذّات هي عين الصِّفات، فهذه الصِّفات تشير إلى مصداق ووجود واحد وذلك الوجود الواحد هو الذّات الإلهيَّة، فالحاصل هو القول بالعينيَّة.
3. التَّوحيد في الخالقيَّة:
وهو بمعنى أنَّ الخالق الوحيد هو الله تبارك وتعالى لا غير، ومرادنا من الخلق هنا هو الإيجاد من العدم على نحو الاستقلالية، أي أنَّه كان هناك شيء معدوم وتمَّ إخراجه من العدم إلى حيِّز الوجود من دون مأذونيَّة أحد، وهذا هو الخلق الَّذي هو منحصر في الله تبارك وتعالى، ويسمّى هذا الخلق خلقاً حقيقيّا وأشرت لهذا المعنى حتى لا يتوهَّم البعض بأنَّ المراد من الخلق ما يستعمل مجازاً -كخلق النَّبي عيسىg للطير كما ذكر في الآية([24])- أي بمأذونيَّة من الله تبارك وتعالى، لا على نحو الاستقلاليَّة كما في الخلق الحقيقيِّ المنحصر في الله تبارك وتعالى.
4. التَّوحيد في الرّبوبيَّة:
بمعنى أنَّ المدبِّر الوحيد لهذا الكون على نحو الاستقلال هو الله تبارك وتعالى، وبعبارة أخرى نقول هو بمعنى أنَّ تدبير وتنظيم وتنسيق العالم الإمكاني بما فيه من موجودات ممكنة كلّها بيد الله تبارك وتعالى، وما في العالم الإمكاني من أسباب وعلل كونية إنّما هي جنود لله ويعملون بأمره، وأنَّهم لا يدبِّرون باستقلاليَّتهم، فلا مدبِّر لهذا الكون بالاستقلال إلا الله تبارك وتعالى.
5. التَّوحيد في العبادة:
بمعنى أنَّ الَّذي حقُّه أنْ يُعبد هو الله تبارك وتعالى لا غير، فلا معبود سواه جلَّ وعلا، والمراد من العبادة هو الخضوع والتّذلل -لفظاً أو عملاً- مع شرط الاعتقاد بأنَّ المخضوع له هو خالق وربٌّ ومالك -وهي من شؤون الألوهيَّة-.
الوقفة الرّابعة: وهي في طرح الأدلَّة على التَّوحيد
وسنقتصر على ذكر الأدلَّة على التَّوحيد في الذّات، بنوعيه، التَّوحيد الأحديّ، التَّوحيد الواحديّ، وهنا نشير إلى أدلة عقليَّة ومن ثُّم إلى أدلَّة نقليَّة:
أولاً: في ذكر الأدلَّة العقليَّة:
الدليل العقليُّ على الأحديَّة:
للاستدلال عقلاً على كون الذّات الإلهيَّة بسيطة غير مركبة -على التَّوحيد الأحدي- يمكن أن يقال:
التَّركيب يتصوَّر على قسمين:
القِسم الأوَّل: التَّركيب العقليُّ، وبعبارة أخرى التَّركيب من الأجزاء العقليَّة -أي أنَّه مركب تركيباً في العقل ولا دخل له بالمّادة-، وذلك كالمركب من جنس وفصل كالإنسان، فالإنسان مركب من جنس -وهو الحيوانيَّة- وفصل-وهو النّاطقيَّة- فمثل هذا التَّركيب تركيب مركب من أجزاء عقليَّة؛ إذ إنَّك لا ترى حيوانيَّة وناطقيَّة في الخارج فهذا تركيب من أجزاء عقليَّة فالنّوع الأوّل من التَّركيب هو التَّركيب من الأجزاء العقليَّة فقط.
القِسم الثّاني: التَّركيب الخارجيُّ كتركيب الشَّيء من أجزاء خارجيَّة من عناصر مختلفة، كالعناصر المعدنيَّة والمركبات الكيميائيَّة وكبدن الإنسان وغيرها.
الله تبارك وتعالى بسيط غير مركب لا بالتَّركيب العقليِّ ولا بالتَّركيب الخارجيِّ، فأمّا الدَّليل على كونه غير مركب بالتَّركيب الخارجي هو أنَّ الشَّيء المركب من مجموعة أجزاء يحتاج في وجوده إلى تلك الأشياء، والمحتاج لغيره معلول له، والله واجب وجود غنيٌّ بالذّات فلا يحتاج لأجزاء توجِده.
وأمّا الدَّليل على كونه غير مركب بالتَّركيب العقليِّ فلأنَّ الَّذي يركب بالتَّركيب العقليِّ -بأنْ يكون له جنس وفصل- هو ما كان له ماهيَّة، وواجب الوجود لا ماهيَّة له؛ إذ إنَّ الماهيَّة ليست أصيلة فلو قلت: إنَّ لواجب الوجود بالذّات ماهيَّة، ونظرت للماهيَّة بما هي هي -أيْ إلى عينها وذاتها- فستلاحظ أنَّها متساوية النِّسبة بين الوجود والعدم، فيمكن أنْ يفاض عليها الوجود ويمكن ألّا يفاض عليها الوجود فتكون عدماً، فهي متساوية النِّسبة.
والله لا يمكن أن يكون متساوي النّسبة بين الوجود والعدم؛ لأنَّه ضروريُّ الوجود فلا يصحُّ أنْ يكون الله مركباً بالتَّركيب الماهويِّ العقليِّ؛ وذلك لأنَّ كلَّ ماهيَّة من حيث هي هي تكون ممكنة، فالَّذي ليس بممكن لا ماهيَّة له، والله ليس بممكن فلا ماهيَّة له، فهو غير مركب بالتَّركيب العقليّ، وقد أشار الشَّيخ السّبحانيُّ لهذا المعنى بقوله: "فهذا النّوع -وهو يقصد التَّركيب العقليّ- محال عليه سبحانه إذ لوكان له ماهيَّة وشأن الماهيَّة في حدِّ ذاتها أن تكون عارية عن الوجود والعدم قابلة لعروضهما فعنذئذ يطرح السّؤال نفسه: ما هي العلة الَّتي أفاضت عليها الوجود والمحتاج إلى شي آخر يفيض الوجود على ماهيته يكون ممكنا لا واجباً ولأجل ذلك ذهب الحكماء من الإلهيين إلى بساطة ذاته وتنزيهه عن أيِّ تركيبٍ عقلي وبالتّالي يثبت كون منزَّهاً عن الماهيَّة"([25]).
وبهذا يثبت كون الذّات الإلهيَّة ذات بسيطة غير مركبة، وهناك أدلَّة أخرى على ذلك لكن نقتصر على ذكر ما تقدَّم.
الدّليل العقليّ على الواحدية:
للاستدلال عقلاً على كون الله تبارك وتعالى واحد لا شريك له -أي على كون الذّات الإلهيَّة واحدة لا شريك ولا مثيل لها- يمكن أن يقال:
يمكن ذكر دليلين على ذلك:
الأوّل: التَّعدد يستلزم التَّركيب:
وحاصله أنَّك بمجرَّد أن تقول بأنَّ هناك واجبَيْ وجود لَلَزم تركبُّهما، والواجب لا يكون مركباً كما تقدم في الدَّليل العقليِّ على التَّوحيد الأحديِّ.
والَّذي يوضح لنا أنَّه لو كان في الوجود واجبان للزم التَّركيب هو أنَّه لا بدَّ من أن يُميِّز أحدَهما عن الآخر شيءٌ وراء ذلك الأمر المشترك وهو واجبيَّة الوجود، لأنَّك إذا لم تميِّز أحدهما عن الأخر لصارا شيئاً واحداً، وإذا أتيت بأمر يميِّز أحدَهما عن الآخر صار كلٌّ منهما مركباً من الأمر المشترك بينهما مع ذلك الأمر الَّذي يميِّز كلاً منهما عن الآخر، وقد تقدَّم بأنَّ واجب الوجود لا يكون مركباً إذ إنَّه بسيط غير مركب([26]).
الثّاني: صرف الوجود لا يتثنّى ولا يتكرر:
وهذا البرهان مكوَّن من صغرى وكبرى ثم النَّتيجة:
فالصُّغرى: هي أنَّ الله تبارك وتعالى وجود صِرف.
والكبرى: هي أنَّ صرف الوجود لا يتثنّى ولا يتكرَّر.
والنَّتيجة: هي أنَّ الله تبارك وتعالى لا يتثنّى ولا يتكرَّر.
وللتَّوضيح نقول: الصَّرافة بمعنى المحضيَّة، أي فقط شيء واحد، كما لو قلت لك (سواد)، فالمراد من الصّرف فقط اللون الأسود من دون أن يكون معه شي آخر، وكذلك صرف الوجود بمعنى فقط وجود لا شي آخر معه.
ثمَّ إنَّ صِرف الشَّيء الَّذي تقدم معناه لا يمكن أن يتثنّى ولا يتكرر، فلا يكون شيئين ولا يمكن أن يتكرَّر، وإنما هو شيء واحد؛ إذ إنَّك إذا فرضت أنَّه يتثنّى ويتكرَّر، فلا بدَّ مِن أن يكون لهذين الشَّيئين جهة افتراق، فهما مشتركان في كونهما سواد، مثلا فيما لوكان عندك سوادين فهما يشتركان في كون كل منهما سواد ولكن لا بدَّ من جهة افتراق حتى تحصل اثنينيَّة، وبمجرد أنْ تأتي بجهة افتراق ما عاد شيئاً واحداً، -أي ما عاد صرفاً- بل اثنان، فنفهم أن صرف الوجود لا يتثنّى ولا يتكرر.
ثم بعد ذلك قالوا بأنَّ واجب الوجود بالذّات هو صرف الوجود؛ إذ إنَّ الله لا ماهيَّة له -وقد أثبتنا أنَّه لا ماهيَّة له فيما تقدَّم- وإنَّما هو فقط وجود فهو صرف الوجود، وبما أنَّه تبارك وتعالى صرف الوجود فهو لا يتثنّى ولا يتكرر، أي أنَّ الله تبارك وتعالى واحد لا ثاني له ولا نظير وهو المطلوب([27]).
هذا في طرح الأدلَّة العقليَّة على التَّوحيد في الذّات بنوعيه.
ثانياً: في ذكر الأدلَّة النّقليَّة:
الأوَّل: ما جاء في صدر وذيل سورة التَّوحيد المباركة، فصدر الآية وهو قوله تعالى {قل هو الله أحد} إشارةٌ للتوحيد الأحديِّ -أي أنَّ ذاته بسيطة غير مركبة-، وأمّا ذيل الآية وهو قوله تعالى {ولم يكن له كفوا أحد} إشارة إلى التَّوحيد الواحدي- أي نفي الشّريك والنّظير له-.
الثّاني: قوله تعالى {وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ}(النَّحل: 51).
الثّالث: ما روي عن أمير المؤمنينg حينما سُئل عن وحدانية الله تعالى، فذكر الأميرg أربعة معان، اثنان منها لا يليقان بساحته تعالى واثنان منها ثابتان له.
فاللَّذان لا يليقان بساحته هما الوحدة المفهوميَّة والوحدة العدديَّة، وليسا محلَّ الكلام، وأمّا اللَّذان ثابتان له تعالى فهما بساطة ذاته، وعدم المثيل والنّظير له حيث قال الأميرg: >وَأَمَّا اَلْوَجْهَانِ اَللَّذَانِ يَثْبُتَانِ فِيهِ فَقَوْلُ اَلْقَائِلِ هُوَ وَاحِدٌ لَيْسَ لَهُ فِي اَلْأَشْيَاءِ شِبْهٌ -إشارة للتوحيد الواحدي- كَذَلِكَ رَبُّنَا، وقَوْلُ اَلْقَائِلِ إِنَّهُ عَزَّ وجَلَّ أَحَدِيُّ اَلْمَعْنَى يَعْنِي بِهِ أَنَّهُ لاَ يَنْقَسِمُ فِي وُجُودٍ ولاَ عَقْلٍ ولاَ وَهْمٍ -إشارة للتوحيد الاحدي-<([28]).
الوقفة الخامسة: في بيان نظريَّة التَّثليث عند النَّصارى ونقدها
أولاً: في بيان هذه النَّظريَّة
فالَّذي يظهر من كلمات المسيحيِّين أنَّ مسألة التَّثليث من المسائل الأساسيَّة في عقيدتهم، ولا بدَّ لكلِّ مَن يريد أنْ يُصبح مسيحيّا أنْ يَعتقد بها.
والحاصل من هذه النَّظريَّة هو أنَّهم يرَوْن بأنَّ الإله واحد، لكنَّه في ثلاثة أشخاص وفي عين الوقت، يرون أنَّ هذه الثّلاثة الأشخاصّ هي شي واحد وهو الله، فيقولون: الرّبُّ هو الأب، الرَّبُّ الابن، وروح القُدُس([29])، وعلى الرُّغم من ذلك، يرَوْن أنْفسهم موحدين غير مشركين، ويقولون بأنَّ هذه العقيدة عقيدة تعبديَّة محضة، وهي فوق التَّجربيّات الحسيَّة وفوق الإدراكات العقليَّة المحدودة للإنسان ولا سبيل لنفيها أو إثباتها إلا الوحي الإلهي.
ثانياً: في نقد هذه النّظريَّة من خلال طريقين بل ثلاثة
الطَّريق الأوَّل: هذه العقيدة من الواضح جداً، أنَّها تشتمل على التَّناقض الصَّريح؛ إذ إنَّها من جانب تبيِّن أنَّ الثَّلاثة المتشخِّص فيها الإله، كلُّ واحد منهم متشخِّص عن الآخر، ومن جانب آخر تبيِّن أنَّ الثّلاثة كلّهم واحد وهذا تناقض، فمن جهة يعرفون كلَّ واحد من الآلهة الثّلاثة بأنَّه متشخِّص ومتميِّز عن الآخر وفي الوقت نفسه يعتبرون الجميع واحداً، بل ومع ذلك يُسندون ذلك إلى ساحة الوحي الإلهيِّ وهذا غير ممكن؛ إذ إنَّه لا يمكن الاعتقاد بشيء يضادُّ بداهة العقل ثمَّ إسناده إلى ساحة الوحي الإلهيِّ.
الطَّريق الثّاني: نسأل مَن يعتقد بهذه النَّظريَّة -نظريَّة التَّثليث- ما هو المقصود مِن الآلهة الثّلاثة الَّتي تتشكَّل منها الطَّبيعة الإلهيَّة الواحدة؟
فإنَّ لما تقولونه أحد صورتين:
الصورة الأولى: إنَّ لكلِّ واحد من هذه الإلهة الثَّلاثة وجود مستقلّ، بحيث يكون لكلِّ منهم تشخص وجود خاصّ به، فيكون لكلِّ واحد منهم خاصّة مميّزة به عن الباقي، وهذا هو عين الاعتقاد بتعدُّد الواجب بالذّات، وقد أبطلنا هذا فيما تقدَّم.
الصورة الثّانية: أن تكون كلُّ هذه الثّلاثة موجودة بوجود واحد، -أي في شيء واحد-، وهذا واضح البطلان أيضا؛ إذ القول به يستلزم أنْ يكون الإله مركباً وقد أثبتنا بطلان ذلك فيما تقدَّم.
الطَّريق الثّالث: من خلال قوله تعالى {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}(المائدة: 72).
وبهذا يتَّضح عدم صحَّة هذه النّظريَّة والعقيدة -نظريَّة وعقيدة التَّثليث-.
الوقفة السّادسة: في طرح بعض الشُّبهات المطروحة على التَّوحيد وردِّها
الشُّبهة الأولى: إله الخير والشّر
وهي ازدواجيَّة أسفرت عن ظهور العقيدة الثّنوية([30])، وهذه الشُّبهة حقيقة لا تتعارض مع التَّوحيد في الذّات، بل تتعارض مع التَّوحيد في الأفعال على صعيد الخالقيَّة؛ إذ إنَّها جعلت البعض يعتقد بوجود خالقَيْن.
توضيح هذه الشُّبهة:
نحن نرى في العالم موجودات خيِّرة وموجودات شرّيرة، واعتماداً على مبدأ السِّنخيَّة -التّناسب بين العلَّة والمعلول- يقتضي أن يكون خالقُ الخير غيرَ خالق الشَّر؛ إذ لو كان خالق الخير نفسُه هو خالقَ الشّرِّ لانتقض مبدأ السِّنخية، فيتعيَّن أنْ يكون هناك مبدأين وإلهين إله للخير وإله للشَّرِّ، وبعبارة أخرى يُقال لا يمكن أنْ يكون منشأُ كلِّ ما يشهده الكون من شرٍّ وأذى ومعاناة عائداً إلى الإله الواحد الَّذي هو خير مطلق ويريد الخير لعباده، وعلى إثْر ذلك لا بدَّ من وجود إله آخر خالقٍ للشَّرِّ.
وقد بادر الثَّنوية من المشركين للاعتقاد بهذا الإله المزعوم، ولذلك قالوا بوجود إلهين -إله للخير وإله للشَّرِّ- لا إله واحد فلا توحيد في الخالقيَّة.
يمكن الرّد على هذه الشّبة بأجوبة عديدة ولكن نقتصر على ذكر جواب واحد:
الجواب: الشَّرُّ أمر قياسيٌّ (نسبيٌّ) وتوضيحه:
اللِّحاظ لحاظان ذاتيٌّ ونسبيٌّ إضافيٌّ، فمثلاً بلحاظ المعنى الذّاتي -مع قطع النَّظر عن الموجودات الأخرى- تقول فلانٌ أبيض، ولكنْ إذا لاحظناه بالنِّسبة لموجود آخر يكون أسود.
فلنطبق هذا المعنى على الشَّرِّ، فمثلاً الأفعى مع السُّم الموجود فيها الَّذي يقال عنه شرٌّ، إذا لاحظناه في حدِّ ذاته من دون نسبته لموجود آخر إلا الأفعى فهو خير؛ إذ إنَّها تدافع عن نفسها بهذا السُّمِّ الموجود فيها، ولكنْ إذا نَسبتَ سمَّ الأفعى إلى الإنسان -مثلاً- صار شراً، فعندما ذهبت الأفعى السّامة إلى الإنسان وسمَّتهُ حصل الشَّرُّ.
ومن الواضح أنَّ نسبة الشَّرِّ تأتي في مرحلة لاحقة على مرحلة الإيجاد، فأولاً يوجد الإنسان وتوجد الأفعى السّامة، ووجودهما في حدِّ ذاته خير، ولكن لمَّا جاءت نسبتُهما إلى بعض في مرحلة لاحقة حصل ووقع الشَّرُّ، فالشَّرُّ يتحقَّق بعد إيجاد الموجودات، فالشَّرُّ مع النَّظر لذات الشَّيء ومع قطع النَّظر عن بقية الموجودات فهو خير، ولكن مع نسبته لموجود آخر قد يكون شراً.
والله تبارك وتعالى يخلق الذّات الموجودة -وجوده النَّفسي- لا النّسبة والمقايسة، والشّرّ ينشأ من خلال نسبة موجود لموجود آخر، وهذه النّسبة والمقايسة تأتي في مرحلة لاحقة لمرحلة الإيجاد، وهذه النّسبة والمقايسة لا تحتاج لمبدأ يحقِّقها؛ وذلك لأنَّها مفهوم انتزاعي -أي أنَّه مكون من طرفين ونسبة- فبمجرَّد تحقق وجود الطّرفين وتحقُّق النِّسبة يوجد الشَّرُّ فلا حاجة لموجد له.
نخلص إلى أنَّ الله تبارك وتعالى لم يخلق الشَّرَّ؛ إذ إنَّ الشَّرَّ ليس أمراً واقعياً يحتاج إلى مبدأ يحقِّقه، وبالتّالي لسنا بحاجة للقول بوجود خالقَين -خالقٍ للخير وخالق للشَّرِّ- وبهذا ترتفع الشُّبهة.
الشُّبهة الثّانية: السّجود لآدم يتعارض مع التَّوحيد في العبادة([31])
وهذه الشُّبهة تتعارض مع القول بالتَّوحيد في العبادة، فقد طرح بعض المناهضين للأديان التَّوحيدية شبهة مضمونها أنَّ طلب الله تعالى من ملائكته السّجودَ لآدمg بعد أنْ خلقه، يتعارض مع عقيدة التَّوحيد في العبادة.
والجواب على هذه الشُّبهة يكون من عدَّة جهات:
الجهة الأولى: هذه الشُّبهة واضحة البطلان؛ إذ الملائكة أُمروا بالسّجود لآدم من قبل الله a ربِّ كل شيء وبارئه، أي أنَّهم لم يفعلوا ذلك بمحض إرادتهم بل استجابوا لأمره تعالى، فالله هو من أمر الملائكة بالسُّجود لآدمg فلا تأتي الشُّبهة.
الجهة الثّانية: قالوا المراد من العبادة هي الخضوع والتّذلُّل مع شرط الاعتقاد بأنَّ المخضوع له هو خالق وربٌّ ومالك، وأنَّ هذه الأمور من شؤون الألوهيَّة، فلو أتى أحد بهذا النَّحو -ألا وهو الخضوع والتّذلُّل مع الاعتقاد بكون المخضوع له هو الإله- من العبادة لغير الله يكون مشركاً، وعلى العكس تماماً ما لو أتى شخص بخضوع لآخر لكنْ من دون الاعتقاد بأنَّه الإله الرَّبُّ الخالق فإنَّه لا يكون مشركاً في العبادة، ومن الواضح أنَّ سجود الملائكة لآدمg لم يكن مع الاعتقاد بكونه الإله فلا ترد الشُّبهة.
ونكتفي بهذا القدر، وإلا هناك شبهات كثيرة جداً طرحت على عقيدة التَّوحيد، وتمَّ ردُّها بردود قويَّة جداً، لكنَّنا نقتصر على ما ذكرناه طلباً للاختصار.
الخاتمة:
توصَّلنا من خلال العرض المتقدِّم إلى مجموعة من النَّتائج حول سورة التَّوحيد المباركة، وما يتفرع عليها:
أولاً: عرفنا فضل هذه السّورة المباركة، فتقدَّم أنَّ لهذه السّورة المباركة ثمرات عديدة يتحصَّل عليها قارئها، فمن ضمن تلك الثّمرات الَّتي يتحصَّل عليها قارئها أنَّها: تجلب حبَّ الله، وتعدل قراءة ثلث القرآن، وغفران الذنوب، وتدفع الفقر وتزيد في الرِّزق وغيرها.
ثانياً: عرفنا الخصائص الَّتي ميَّزت هذه السّورة المباركة، فمن ضمنها: موضوعُها إذ إنَّ موضوعها عن أساس الدّين وهو التَّوحيد، وتواترُ روايات المعصومينi في بيان مكانتها في الإسلام.
ثالثاً: عرفنا سبب نزولها، وهو أنَّ اليهود طلبوا من النَّبيِّ الأكرمe أن يصف لهم الله تبارك وتعالى، فجاءت هذه السّورة لتبيِّن أنَّ ذات الله في نهاية الخفاء لا تدركها أفكار الإنسان.
رابعاً: عرفنا تفسير مفردات هذه السّورة المباركة، وأشرنا في ذلك إلى عدَّة أمور منها:
1. أنَّ ذات الله تبارك وتعالى بسيطة غير مركبة واستدللنا بالأدلَّة على ذلك.
2. أنَّ الله تبارك وتعالى هو السّيد الَّذي يُقصد إليه بالحوائج على الإطلاق، أي في جميع الحوائج.
3. أنَّ الله تبارك وتعالى ليس بوالد ولا مولود واستدللنا بالأدلَّة على ذلك.
4. أنَّه لا نظير ولا شبيه لله تبارك وتعالى. وكذا وغيرها من الأمور الجزئيَّة في كل آية آية على ما تقدَّم.
5. أنَّ علم التَّوحيد من أشرف العلوم.
6. بعض الأحكام الفقهية حول هذه السّورة المباركة الَّتي من ضمنها: أنَّه لا يجوز العدول عن قراءتها في الصَّلاة فيما لو شُرِع فيها عدا مورد واحد مستثنى، ومعرفة صور قراءة الآية الأخيرة منها.
7. بعض أقسام التَّوحيد الَّتي من ضمنها: التَّوحيد في الذّات، والتَّوحيد في الصّفات، والتَّوحيد في الخالقية، والتَّوحيد في الرّبوبية، والتَّوحيد في العبادة.
8. الأدلَّة على التَّوحيد في الذّات بالخصوص، وذكرنا:
أ. أدلَّة عقليَّة كمثل أنَّ التَّعدد يستلزم التَّركيب، وأنَّ صرف الوجود لا يتثنّى ولا يتكرر.
ب. أدلَّة نقليَّة والَّتي من ضمنها ما جاء في صدر وذيل سورة التَّوحيد المباركة.
9. المراد من نظريَّة التَّثليث والرّد عليها وإبطالها.
10. في طرح بعض الشّبهات الواردة على التَّوحيد كشبهة إله الخير وإله الشَّرِّ وشبهة السُّجود لنبيِّ الله آدمg مع الرَّدِّ عليهما بالأدلَّة الوافية على مرَّ.
والحمد لله أولاً وآخراً، والصَّلاة والسَّلام على رسوله الأمين، وعلى آله الغرِّ الميامين.
([1]) تفسير البرهان، ج 5، ص 198.
([2]) تفسير الأمثل، ص 599. أيضاً: تفسير نور الثقلين، ج5، ص507، ح42.
([3]) تفسير البرهان، ص 423. أيضاً: الواضح في التفسير، ص494، في كتاب كمال الدين عن علي×.
([4]) تفسير الأمثل، ص600.
([5]) تفسير الأمثل، ص600. وتفسير البرهان، ص419. والكافي ج2 ص454 ح11.
([6]) تفسير البرهان، ص419. والكافي، ج2، ص455، ح13.
([7]) بحار الأنوار، ج73، ص166.
([8]) وسائل الشّيعة، الباب 33، ص227.
([9]) الواضح في التفسير، ص493.
([10]) تفسير الميزان، ج20، ص451.
([11]) الواضح في التفسير، ص493.
([12]) تفسير الأمثل، ص601.
([13]) تفسير الميزان، ص448.
([14]) تفسير البرهان، ص430.
([15]) تفسير البرهان، ص430.
([16]) تفسير الأمثل، ص630.
([17]) تفسير الميزان، ص450.
([18]) تفسير الأمثل، ص604.
([19]) تفسير الميزان، ص449.
([20]) نهج البلاغة، الخطبة 186.
([21]) تفسير البرهان، ج8، ص434. وتفسير القميّ, ج2، ص451.
([22]) انظر: منهاج الصالحين، مسألة 613، يقولان: "ويجوز في (كفوا) أن يقرأ بضم الفاء وبسكونها، مع الهمزة أوالواو".
([23]) انظر: منهاج الصالحين، مسألة 623.
([24]) انظر: آل عمران: 49. وجاء فيها: {وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآَيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ...}.
([25]) الإلهيات، السبحاني، ج2، ص30.
([26]) الإلهيات، السبحاني، ج2، ص14.
([27]) الإلهيات، السبحاني، ج2، ص15.
([28]) تفسير الأمثل ص604.
([29]) الإلهيات، السبحاني، ج2، ص20.
([30]) أجوبة الشّبهات الكلامية، ج1، ص399.
([31]) أجوبة الشّبهات الكلامية، ج1، ص412.



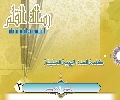






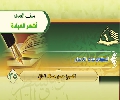

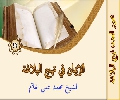


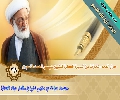

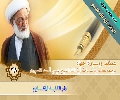


0 التعليق
ارسال التعليق